|
وتزامن هذا الاختيار مع تطوّرات دولية جعلت ألمانيا من خلال مشاركتها العسكرية عالميا تخلع عن نفسها آخر مخلّفات هزيمتها في الحرب العالمية الثانية قبل أكثر من ستين عاما -باستثناء الحمل الثقيل تحت عنوان المحرقة النازية لليهود- حتى غدت في هذه الأثناء في الصدارة على مسرح صناعة القرار العالمي، مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، دون أن يكون لها مثل تلك العضوية رسميا. هل يعني ذلك أنّ انتخاب بينيديكت السادس عشر وراء أبواب مغلقة لمدة 28 ساعة على أعضاء مجلس الانتخاب كان انتخابا سياسيا؟ لا يمكن إلغاء العامل السياسي كليّا، ولكن لا ريب أنّ الوصول إلى منصب البابوية في روما لا يتحقّق إلاّ لمن بلغ في منزلته الكنسية أعلى الرتب، وهذا ما يسري على بينيديكت أيضا، الذي بلغ الثامنة والسبعين من عمره عند اختياره، فهو يجيد الألمانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والأسبانية واللاتينية، كما يقرأ اللغتين الإغريقية والعبرية. كما بلغ على المستوى العلمي التخصّصي في علم الأديان (الكاثوليكي) وفي المناصب الكنسية، ما لم يبلغه سواه من معاصريه، وما جعل اختياره متوقّعا، بل لم تستغرق عملية الاختيار مدة طويلة عندما نقارن 28 ساعة مع عدّة أيام بل عدة أسابيع أحيانا، استغرقتها عمليات اختيار كثير من أسلافه. الصفحة الشبكية الرسمية لدولة الفاتيكان تتحدّث عن سيرة حياة يوزيف آلويس راتسينجر، بادئة بولادته لأسرة ريفية تعيش في ظروف متواضعة، ولا يرد فيها ذكر عمّ أبيه جورج راتسينجر، الذي كان قسيسا وعضوا في مجلس الرايخ الألماني آنذاك، كما كان أخوه جورج راتسينجر قسيسا أيضا. وتذكر الصفحة الشبكية أنّه عايش كيف اعتدى النازيون على أحد القساوسة بالضرب، مؤكّدة عداء النازية للكنيسة الكاثوليكية، ومتجاوزة ما يقال عنها في تلك الحقبة وما يُنشر من شبهات حول سكوتها عن النازية أو حتى التعاون معها، وهذا ما ارتبط تاريخيا باسم البابا بيوس الثاني عشر (شغل المنصب من 1939 حتى وفاته 1958م). كما تذكر الصفحة الرسمية بعبارة واحدة أنّ راتسينجر "طُلب في الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية لخدمة سلاح الدفاع الجوي"، ولا تذكر أنّه كان قبل تلك الفترة -أي منذ كان في الرابعة عشرة من عمره- عضوا فيما سمّي "شبيبة هتلر" وأنّه قام بعدد من المهامّ آنذاك، ولكنّ مصادر كنسية أخرى تشير إلى أنّ جميع طلبةِ معاهدَ متميّزةٍ بعينها، كمعهد "سانت ميشائيل" الذي انتسب إليه، كانوا يُضمّون قسرا إلى تلك المنظمة الشبابية، لضمان انضباطهم. وفي سائر الأحوال فإنّ هذه الفترة -رغم كونها محدودة الأثر على حياته- لم تمنع من انتشار الانزعاج في الأوساط اليهودية بسبب اختياره، إلى درجة قول بعض المسؤولين الإسرائيليين "اليوم خرج دخان أسود من مبنى الفاتيكان"، في إشارة ذات مغزى إلى الدخان الأبيض الذي يطلقه المسؤولون في الفاتيكان، عندما يتمّ الاتفاق وراء الأبواب المغلقة على اسم البابا الكاثوليكي الجديد، ومضى الموقف الحكومي الإسرائيلي الرسمي إلى الإشارة لخلفيته التاريخية بلهجة دبلوماسية تنطوي على مطالبته بسياسة محدّدة، عبر القول إنّ "هذا البابا الجديد سيكون بخلفيّته مثل سلفه تماما، صوتا قويا ضدّ العداء للسامية بكافة أشكال ظهوره". البابا البروفيسور الجامعي مع بلوغ سنّ الشباب بدأ راتسينجر دراسة الفلسفة واللاهوت (علم الأديان الكاثوليكي)، في ميونيخ، وقبل حصوله على الدكتوراة عام 1953م بعامين تمّ تعيينه "قسيسا"، وكانت رسالة الدكتوراة التي كتبها حول "شعب الإله وبيته في تعاليم آوجوستينوس الكنسية". ويُذكر أنّه لم يكن من أنصار "توما الأكويني" الذي توفي عام 1274م، ويعتبر من أوائل المجدّدين الكنسيين عبر محاولته بين التعاليم الكنسية وفلسفة "أرسطو" العقلانية، متأثرا بما نُقل عن الفيلسوف العربي ابن رشد، أمّا آوجوستينوس الذي توفي عام 430م، فيعتبر أشهر مراجع التعاليم الكنسية إطلاقا، ويمكن ذكر ثلاثة إنجازات كبرى له، ذات علاقة باقتناعات البابا الكاثوليكي الحالي: 1- ترسيخ ما عُرف بالدوجما الكنسية، أي الإملاءات العقدية الكنسية، فما تقوله الكنيسة هو "الدين" ويجب أن يطاع، وإن تناقض مع العقل، والكنيسة هي "البشر" الذين يبلغون إرادة الله لسواهم (فقد استخدم الخالق مخلوقه الإنسان وأوحى إليه لينطق بكلمته إلى العالم) وفق مقولة تُنسب إلى بينيديكت السادس عشر، والإنجيل (كلمة الله التي أوصلها عبر المجتمع الإنساني) ويوجد (منطق داخلي يحكم الإنجيل المسيحي يجيز له ويتطلب أيضا تعديله وتطبيقه بحسب الأوضاع الجديدة). والجدير بالذكر أن من أهمّ القضايا العقدية التي تستحوذ على اهتمام البابا بينيديكت السادس عشر قضية العلاقة بين العقل والإيمان، والتي كانت موضوع محاضرته المختلف إليها بسبب إساءته للإسلام فيها، عبر القول بوجود تناقض بينه وبين العقل والعلم. 2- تثبيت الأسلوب الكنسي في معاملة من يرفض الطاعة، وينكر –أو حتى يشكّك في- ما تقول به الكنيسة الكاثوليكية على صعيد العقيدة، فيُتّهم آنذاك بالهرطقة، وقد حدّد أوجوستينوس لمعاملته درجات متتالية، تبدأ بمحاولة الإقناع، ثمّ ممارسة الشدّة باعتدال، ثمّ العقاب والنفي، وتنتهي إلى الإعدام. وقد طبّقت الكنيسة ذلك زهاء تسعة قرون عندما امتلكت السلطة مع القياصرة أو بمفردها، وربّما استوحى بينيديكت السادس عشر من ذلك قوله في المحاضرة المسيئة عن الآية الكريمة {لا إكراه في الدين} إنّ محمدا -صلّى الله عليه وسلّم- طبّقها فقط قبل أن يمتلك السلطة!. 3- بعد خلافات كنسية حادّة استمرّت ثلاثة قرون من قبل، كان أوجستينوس هو الذي أقرّ صياغة عقيدة التثليث التي تبنّتها الكنيسة من بعد، ومحورها قوله "المسيح إله إنسان وإنسان إله في وقت واحد"، وأضيف لاحقا عليها اعتبار الروح القدس هو الأقنوم الإلهيّ الثالث، واستمرّت الخلافات الكنسية على التفاصيل بضعة قرون أخرى، وهي في مقدّمة أسباب تعدّد الكنائس المسيحية، كما أنّها من بين أسباب أخرى من وراء ما وقع من حروب دينية طاحنة آنذاك، كحرب المائة عام وحرب الثلاثين عاما وغيرها، وهو ما يذكّر بدوره بحديث بينيديكت السادس عشر في المحاضرة المشار إليها عن مسألة العنف، وتناقضه مع الدين. وممّا يشير أيضا إلى ارتباط فكر البابا الكاثوليكي بتعاليم أوجستينوس أنّه بعد حصوله على درجة الأستاذية عام 1957م، انتُدب لتدريس فرع "الإملاءات العقدية الكنسية" وفرع "الدين الأصولي"، ولاحقا "تاريخ الإملاءات العقدية الكنسية" وغير ذلك في عدد من كليّات علم اللاهوت الكنسي في الجامعات الألمانية. وكان لإنجازاته العلمية دورها في لفت الأنظار إليه، ليعمل خبيرا لدى رئاسة أسقفية كولونيا، ومؤتمر الأساقفة الألمان، واللجنة العالمية للشؤون الدينية، كما أصدر مع علماء دين آخرين مجلة "كومنيو" عام 1972م، وفي 25-3-1977م عيّنه البابا بولص السادس في رتبة كبير أساقفة ميونيخ وفرايزينج، وكلاهما في ولاية بافاريا التي ولد ونشأ فيها، والتي تنتشر فيها الكاثوليكية انتشارا واسعا على النقيض من ولايات أخرى تنتشر فيها البروتستانتية في ألمانيا، التي شهدت ميلاد المذهب البروتستانتي فيما اعتبر ثورة "التنوير" الأولى على الكنيسة الكاثوليكية في أواخر القرون الوسطى الأوروبية. وبعد شهرين فقط جرى تنصيبه (في عام 1977م نفسه) في مرتبة كاردينال، وبدأت أبواب الفاتيكان تُفتح له على أوسع نطاق، فكان من المشاركين في اختيار البابا يوحنا بولص الثاني عام 1978م، وبدأ يؤدّي سلسلة من المهام الكبرى داخل الفاتيكان، بدءا بتعيينه مبعوثا خاصا للمؤتمر الدولي الثالث للماريولوجية-وهي الجزء المخصّص عن مريم البتول في فرع الإملاءات العقدية الكنسية- مرورا برئاسة العديد من المؤتمرات واللجان التابعة للفاتيكان. ويعدّد بعض المصادر 17 منصبا رئيسيا منها قبل استلامه كرسي البابوية، من أهمّها مسؤوليته عن لجنة شؤون الإيمان، التي تعتبر في محور صياغة القضايا العقدية وفق الرؤية الكاثوليكية، وعضوية "سكرتارية الفاتيكان للعلاقات مع الدول الأخرى"، فضلا عن عضويته الفخرية في "الأكاديمية البابوية للعلوم"، تقديرا لإنجازاته التي كان من أشهرها في بداية حياته العلمية كتاب "مدخل إلى المسيحية" من عام 1968م، ومن أشهرها "الإملاءات العقدية الكنسية والدعوة"، بينما كانت أوّل وثيقة كنسية أصدرها بعد تسلمه منصب البابوية بعنوان "الإله هو المحبة". البابا الكاثوليكي المحافظ والسياسي
وكان قد اشتهر لفترة من الزمن بمواقف اعتُبرت ثورية من خلال دعوته إلى تخفيف "انفراد" البابا الكاثوليكي في روما بالقرار، وضرورة أن يعبّر ما يصدر عن الكنيسة في روما عن "الجميع"، فاعتُبر من التجديديين الإصلاحيين، ولكنّ هذه الأفكار كانت ممّا ورد في فترة شبابه في كتابه "مدخل إلى المسيحية" من عام 1968م، بينما يقول هو نفسه حول تراجعه عن كثير منها، إنّه تأثر بمصادماته في جامعة توبينجن الألمانية مع دعاة الإلحاد من تلك الفترة. وتحوّلت النظرة إلى بينيديكت منذ عهد سلفه بولص الثاني، إلى اعتباره من المحافظين في الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما ينصبّ في الدرجة الأولى على مواقفه التي خالف فيها كثيرا من الأساقفة الألمان الآخرين من قبل انتقاله إلى روما، فكان من وراء انسحابِ الكنيسة الكاثوليكية الألمانية من اللجنة التابعة للدولة والكنيسة، تحت عنوان "تقديم المشورة للراغبات في الإجهاض"، وكان الانسحاب بعد صدور قانون يسمح بالإجهاض بعد تلك المشورة، فلا تكون ملزمة للمرأة. كما أنّه معروف بشدّة اعتراضه على جميع ما شهدته البلدان الغربية من تطوّرات جديدة، تبيح الشذوذ الجنسي، وتعتبر المعاشرة بين ما يوصف بالمثليين جنسيا مشروعة، وتشرّع لذلك القوانين، بما في ذلك "حقّ الزواج المدني"، ولم يكن ذلك دون أثر سياسي، ومن ذلك مثلا أنّ توقيت تأكيده لهذا الموقف جاء مع طرح مسألة الإجهاض في معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2004م، ممّا ساهم في سقوط جون كيري آنذاك. وهذا بعض ما يجلب على بينيديكت شبهة تلاقيه مع أفكار المحافظين الجدد، من حيث إعادة المسيحية إلى مركز الثقل في صناعة القرار السياسي، فهو تلاقٍ بمنظور كاثوليكي بغض النظر عن منظورهم "الصهيوني المسيحي". ويؤخذ عليه بهذا الصدد عدم اتخاذه موقفا حاسما في الاعتراض على الحروب "الوقائية وغير الوقائية" الجارية على النقيض من سلفه، وهذا رغم كثرة حديثه عن أنّ الحرب تتناقض مع الإيمان كما ورد في محاضرته التي تضمنت الإساءة إلى الإسلام، إلى جانب مطالبة المسلمين بإلغاء الجهاد أو ما أسماه "الحرب المقدّسة". ويُنتقد أيضا بسبب موقفه من الحرب العدوانية ضدّ لبنان مؤخرا، والتي أثارت معارضة شعبية واسعة النطاق في أوروبا، وقد كان جوابه عندما سئل عن موقفه من مجرى الأحداث تعميميا بصورة ملحوظة، وخاليا من أيّ إدانة، بقوله: (ليس لدينا بالطبع سلطة سياسية ولا نريدها، ولكن نناشد المسيحيين وجميع من يشعرون بصورة ما أنّهم مخاطَبون بكلمة الكرسي المقدس -يقصد: الكرسي البابوي- تعبئة سائر القوى التي تدرك أنّ الحرب هي الحل السيّئ للجميع، بمن في ذلك من يبدو في موقع المنتصر، ونحن في أوروبا نعلم ذلك تماما من خلال الحربين العالميتين، وما نحتاج إليه جميعا هو السلام. وتوجد جماعة مسيحية كبيرة في لبنان، ويوجد مسيحيون عرب ومسيحيون في إسرائيل، ويشعر المسيحيون في العالم كافّة بالقلق على هذه البلدان الغالية، نريد تعبئة القوى الأخلاقية التي يكون لديها الاستعداد للاقتناع بضرورة أن نعيش مع بعضنا، وعلى السياسيين أن يجدوا الطرق التي تحقق ذلك بأسرع وقت ممكن وقبل كلّ شيء بصورة دائمة)، كما ورد نصا في مقابلة إعلامية مستفيضة ونادرة، أجراها معه في مطلع آب/ أغسطس 2006م، ممثلو ثلاث محطات تلفازية وإذاعية ألمانية مع ممثل إذاعة الفاتيكان، قبيل زيارته الأخيرة إلى بافاريا في ألمانيا. ومن يتعمّق في التأمّل في هذه الكلمات لا يجدها بعيدة كثيرا عمّا كان المسؤولون الأمريكيون يطرحونه في ثوب أخلاقي في فترة سعيهم لتأجيل اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار آنذاك. "الفم الذهبي" والحوار بشروط كاثوليكية يشمل تشدّد بينيديكت الجانب العقدي أيضا، كما يؤخذ من مشاركته مشاركة رئيسية في صياغة وثيقة "تعاليم إلهية" في عهد يوحنا بولص الثاني، والتي نشرت المخاوف من تجدّد سوء العلاقة بين الكاثوليك والبروتستانت، وكذلك مشاركته في صياغة وثيقة بابوية تحظر المناصب الكنسية العليا على النساء. وبهذا الصدد أُطلق على راتسينجر لقب "الفم الذهبي"، في إشارة إلى يوحنا كروزوستوموس، ويعني اسمه بالإغريقية "الفم الذهبي"، وكان مشهورا بتشدّده في الإملاءات العقدية الكنسية. كما أنّ في اختياره هو اسم "بينيديكت" في كرسي البابوية إشارة إلى تقديره لمؤسس "أديرة الرهبان" بينيديكت المتوفى عام 547م، وأحد مشاهير الفلسفة المدارسية الكنسية التي رسّخت تطبيق الإملاءات العقدية في الكاثوليكية آنذاك، كما يُشار بهذا الصدد إلى البابا بينيديكت الخامس عشر، المتوفى عام 1922م، الذي اشتهر بمعارضته للحروب بعد الحرب العالمية الأولى، وباستعداده للمصالحة مع فلاسفة الحداثة، بعد ترسيخ العلمانية في أوروبا وتأسيس دولة الفاتيكان في إطار تثبيت دور الكنيسة الديني خارج نطاق الدول الأوروبية. وعلى ضوء هذه الخلفية كانت التساؤلات تصدر من مختلف الاتجاهات حول مستقبل الحوار مع الآخر بمنظور الكنيسة الكاثوليكية في روما. وقد قيل الكثير عن موقف بينيديكت، سواء حول الحوار مع أصحاب المذاهب المسيحية غير الكاثوليكية الرومية، أو الديانات الأخرى. وكان استقبال المسؤولين عن الكنيستين الكاثوليكية نفسها والبروتستانتية لخبر تنصيب البابا بينيديكت مقتصِرا -بلهجة مهذبة- على الإعراب عن الأمل في أن يدعم الحوار المذهبي كسلفه، فلم يتضمّن التعليق على الحدث مثلا الإعراب عن الثقة بمستقبل الحوار أو التفاؤل به. أمّا بيرند جورينج، ممثل ما يُسمّى في ألمانيا الكنيسة الشعبية أو الكنيسة من القاعدة، فقال "إنّنا نعتبر انتخاب راتسينجر كارثة". وكان ممّا يلفت النظر بعد توليه منصبه اهتمامُه الخاص بالحوار أو التقارب مع كنائس بعينها دون سواها، لا سيّما الأورثوذوكسية، فبدأ التواصل مع البطاركة الأورثوذوكسيين في روسيا وتركيا، وفي هذا الإطار تقرّرت دعوته لزيارة تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2006م، فهي ممّا يصنّف في التقارب بين الكنيستين وليس بين الكاثوليكية والإسلام. لا سيّما وأن الأورثوذوكسية كانت مع الكاثوليكية وحدة واحدة في معظم مراحل الخلافات الكنسية أثناء القرون الأربعة الأولى من تاريخ المسيحية، ولم يبدأ الانفصال ويتطوّر إلى قطيعة، إلاّ بعد أن وصل الخلاف مداه بشأن تفاصيل تعاليم التثليث، مثل اعتبار الروح القدس "أقنوما ثالثا" دون مشورة الأورثوذوكسيين مسبقا، ثمّ الخلاف حول موقع ماريا البتول من التثليث، فالخلاف حول الصور والتماثيل. وكان غالب ما انتشر من تساؤلات بصدد الحوار منصبّا على ما إذا كان بينيديكت السادس عشر سيلتزم بسياسة سلفه، يوحنّا بولص الثاني، الذي رأى في استفحال انتشار العلمانية في الغرب، ثمّ في ظهور تيّار "الصهيونية المسيحية" التي أدخلت العنصر العسكري على خلفيّة دينية في نشر الهيمنة الأمريكية، خطرا على الكاثوليكية وعلى الأديان عموما، فضاعف جهوده –السابقة لتلك المرحلة- من أجل تعزيز أسباب الحوار على مختلف المستويات، وكانت له مواقف رمزية عديدة في هذا الإطار، منها على سبيل المثال "تقبيله" لنسخة مطبوعة طباعة فاخرة من المصحف الشريف عند إهدائها إليه عام 1999م. أمّا بينيديكت السادس عشر فيُسجّل له في ميدان الحوار مواقف رمزية من نوع آخر، فقد كان على استعداد للالتقاء مع "الطرف الآخر" في نطاق الديانة المسيحية، مثل الأسقف بيرنارد فيليه رغم طرده من الكنيسة منذ عام 1988م، أو مع عالم الدين الألماني هانس كينج المعروف بنقده للكنيسة الكاثوليكية، أمّا تجاه الإسلام والمسلمين فيلفت النظر لقاؤه مع الكاتبة الإيطالية "أوريانا فالاشي" المعروفة بكتاباتها المتحاملة على الإسلام منذ عشرين عاما على الأقلّ، والمتوفاة يوم 15/9/2006م، وكان اللقاء يوم 27/8/2005م. على أنّ هذه اللقاءات وأمثالها بقيت -كالدعوات إلى الحوار- في نطاق تبني التعاليم الكاثوليكية واعتبارها هي الحقيقة المطلقة، التي يمكن أن تحتضن الآخرين، وفي نطاق مخاوف بينيديكت السادس عشر على الكنيسة الكاثوليكية ومستقبلها، رغم تفاؤله -يوم تنصيبه في باباوية روما- بقوله (الكنيسة حيّة، الكنيسة شابّة). ويعبّر عن نظرته الرسمية، مع ما يوحي بالخوف على الكنيسة الكاثوليكية وعن نظرته بالتالي إلى الحوار، كثير ممّا ورد في المقابلة الإعلامية المشار إليها مثل قوله: (لقد أعاد البشر هيكلة العالم بأنفسهم، وأصبح من العسير العثور على ما وراءه. ليس هذا إذن خاصّا بألمانيا بل شاملا للعالم بأكمله، ويظهر في العالم الغربي تخصيصا. من جهة أخرى يزداد التماسّ بين الغرب وثقافات أخرى يمثّل التديّن بصيغته الأصلية قوّة فاعلة فيها، مع إحساس بالرعب من انتشار البرود في الغرب تجاه الإله. إنّ وجود هذا العنصر المقدس في ثقافات أخرى يستثير العالم الغربي، يستثيرنا نحن الموجودين في نقطة ملتقى كثير من الثقافات). وقد يكون الأقرب إلى تحديد وجهة تحرّكه في الحوار مع البلدان الإسلامية هو العمل على توثيق الروابط مع المسيحيين فيها، وهذا ما يشير إليه في المقابلة نفسها، فعندما سئل عن مستقبل الكنيسة في أوروبا وخارجها كان جوابه: (أودّ بعضَ التدقيق أوّلا، فالمسيحية نشأت في الشرق الأدنى كما نعلم، وكانت لها قوّتها هناك في الدرجة الأولى لمدة طويلة، ثمّ انتشرت بعد فترة في آسيا أكثر بكثير ممّا قد يوحي به الوضع الراهن بعد التغيّرات التي أحدثها انتشار الإسلام. ولاحقا أصبح محور الكنيسة تدريجيا في أوروبا، وهنا استطعنا -ونفخر بذلك- تطويرَها لتأخذ شكلها الحضاري والثقافي. ولكن أعتقد بأهمّية التذكير بالمسيحيين في المشرق-وهم لا يزالون أقلية لها أهميتها-فحاليا يوجد خطر تعرّضهم للهجرة. الخطر كبير أن تصبح المنطقة التي كانت منبع المسيحية خالية من المسيحيين، ويجب علينا أن نساعدهم بقوة ليتمكنوا من البقاء). والجدير بالذكر أنّ هذا الحديث عن "خطر تهجير المسيحيين" تزامن مع مناقشة مشروع قرار تقدّم به إلى مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول من ولاية تكساس، وخصّصه للمطالبة بإدانة "اضطهاد السلطة الفلسطينية للمسيحيين وتحميلها مسؤولية هجرتهم من الأرض المقدّسة". والجدير بالذكر بالمقابل أيضا أنّ ممثلي الكنائس المسيحية في فلسطين سبقوا سواهم إلى رفض الإساءة الصادرة عن بينيديكت السادس عشر للإسلام والمسلمين في محاضرته بألمانيا لاحقا. وقد بات معروفا في هذه الأثناء حجم الأزمة التي أثارتها كلمات بينديكت في محاضرة له في جامعة "ريجينسبورج" بألمانيا، نتيجة ما كان فيها من إساءة للإسلام والمسلمين، وبالتالي عن موقع الإسلام من مسألة الحوار بين الأديان في إطار الفكر الذي يحمله البابا الكاثوليكي في روما. ويشهد على ذلك شهادة ذات مغزى أنّ الاستشهاد الذي أورده بينيديكت السادس عشر على لسان القيصر البيزنطي مانويل بالالويوجوس الثاني (المتوفى عام 1425م) مهاجما فيه الإسلام بافتراءات واضحة، كان قد نقله عن "القرآن. ترجمة وتعليق" بقلم بروفيسور عادل تيودور خوري، اللبناني الأصل، المقيم في ألمانيا، حيث درّس اللاهوت وعمل منذ عشرات السنين في ميداني التبشير والحوار، وقد صدرت آخر نسخة عن الترجمة مع التعليق عليها عام 2005م. وفي هذه الأثناء أبدى الخوري البالغ 76 عاما من عمره، استياءه من "اجتزاء" البابا الكاثوليكي لبعض ما أورده في الكتاب، ممّا نشر انطباعا خاطئا، كما تساءل عن سبب امتناعه في "محاضرة علمية" عن الاستشهاد بمصادر إسلامية عند حديثه عن الإسلام، معتبرا ذلك خروجا عن المنهج العلمي.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
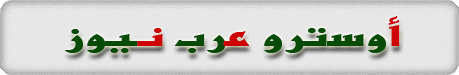
 في نيسان/ إبريل 2005م توفي يوحنا بولص الثاني، ووقع الاختيار على يوزيف آلويس راتسينجر ليخلفه، وكان على ألمانيا والألمان الانتظار 482 عاما بعد البابا الكاثوليكي هادريان السادس، قبل أن يقع الاختيار مجددا على رجل كنسي ألماني الأصل، لاعتلاء كرسي بابوية الكنيسة الكاثوليكية في روما ورئاسة دولة الفاتيكان في 16/4/2005م، وليحمل منذ ذلك اليوم اسم بينيديكت، أو بينيدكتوس (ومعنى الكلمة: مبارك) السادس عشر.
في نيسان/ إبريل 2005م توفي يوحنا بولص الثاني، ووقع الاختيار على يوزيف آلويس راتسينجر ليخلفه، وكان على ألمانيا والألمان الانتظار 482 عاما بعد البابا الكاثوليكي هادريان السادس، قبل أن يقع الاختيار مجددا على رجل كنسي ألماني الأصل، لاعتلاء كرسي بابوية الكنيسة الكاثوليكية في روما ورئاسة دولة الفاتيكان في 16/4/2005م، وليحمل منذ ذلك اليوم اسم بينيديكت، أو بينيدكتوس (ومعنى الكلمة: مبارك) السادس عشر. ربّما كان من خلفيّات التشدّد العقدي لدى بينيديكت، بالإضافة إلى ارتباطه الشديد بتعاليم أوجستينوس، ما يمكن اعتباره ردّة فعل تعود إلى أنّ فترة ارتقائه العلمي الجامعي في ألمانيا تزامنت مع فترة انتشار موجة العزوف عن الكنيسة وعن الدين عموما، وانتشار ما سمّي "الثورة الجنسية" منبثقة عن "ثورة الطلبة" عام 1968م.
ربّما كان من خلفيّات التشدّد العقدي لدى بينيديكت، بالإضافة إلى ارتباطه الشديد بتعاليم أوجستينوس، ما يمكن اعتباره ردّة فعل تعود إلى أنّ فترة ارتقائه العلمي الجامعي في ألمانيا تزامنت مع فترة انتشار موجة العزوف عن الكنيسة وعن الدين عموما، وانتشار ما سمّي "الثورة الجنسية" منبثقة عن "ثورة الطلبة" عام 1968م.